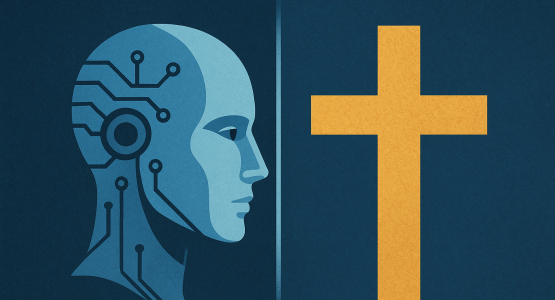تُعرَّف الفلسفة عادة بأنها «محبة الحكمة»، وهذا تعريف يبدو إيجابيًا وجذابًا. غير أن السؤال الحاسم ليس: محبة الحكمة؟ بل: أي حكمة؟ ومن أين تُستمد؟
منذ القرون الأولى للمسيحية، لم يكن موقف الكنيسة من الفلسفة موحّدًا. فقد انقسمت الآراء بين من رأى في الفلسفة أداة تمهيدية يمكن أن تُهيِّئ العقل لقبول الحق، ومن اعتبرها خطرًا يهدد نقاوة الإيمان.
غير أن الإشكال الحقيقي كما درست وبحثت في الموضوع لا يكمن في اتخاذ موقف مؤيد أو معارض، بل بالحري في الخلط بين معنيين مختلفين للفلسفة: الفلسفة كإعمال للعقل والمنطق، والفلسفة كمحتوى عقيدي ورؤية كونية مستقلة عن إعلان الله. إن فض هذا الاشتباك برأيي هو المدخل الصحيح لبناء موقف كتابي سليم.
فالفلاسفة اليونانيون الأوائل سعوا إلى تفسير الوجود عبر افتراض مبدأ مطلق واحد يربط العالم المنظور بغير المنظور. بعضهم قال إن الماء هو الأصل، وآخرون قالوا الهواء أو النار أو غير ذلك. ومن هنا يتضح أن الفلسفة لم تكن مجرد تفكير تجريدي، بل منظورًا كليًا للوجود، أو ما نسميه اليوم رؤية عالمية.
وفي بحثنا هذا أجد انه من الضروري التمييز بين:
قوانين المنطق (كأدوات للتفكير)
والفلسفة كنظام معرفي وعقيدي
فالمنطق، مثل قانون عدم التناقض، ليس عقيدة ولا دينًا، بل أداة للفهم. وكما أن القوانين الفيزيائية تحكم المادة دون أن تكون هي المادة ذاتها، كذلك قوانين المنطق تحكم التفكير دون أن تشكّل محتواه بالطبع.
وكما في العديد من المقالات السابقة أُعيد واقول: الكتاب المقدس لا يعادي العقل، بل يقول أن الإنسان مخلوق على صورة الله. غير أن هذه الصورة تشوّهت بالسقوط، لا سيما على المستوى الفكري، فيما يُعرف بـ التأثيرات الفكرية للخطية الأصلية.
فالإنسان لا يفكّر في فراغ أخلاقي، بل بعقل خاضع للجهل والتحيز والتناقض والعجرفة الفكرية. ومع ذلك، لم تُمحَ صورة الله بالكامل، ولا تزال القدرة على التفكير قائمة، وإن كانت فاسدة وتحتاج إلى تصحيح.
من هنا، لا يُلغى المنطق، بل يُوضَع في موضعه الصحيح:
خادمًا للوحي، لا قاضيًا يحكم عليه.
فنحن لا نفهم لكي نؤمن، بل نؤمن لكي نفهم.
الإشكال الجذري يظهر عندما تتحول الفلسفة من أداة تفكير إلى ديانة طبيعية، أي محاولة لمعرفة الله والوجود اعتمادًا على العقل المشوه والساقط وحده، بمعزل عن الإعلان الإلهي. نرى ذلك بوضوح على سبيل المثال في: إله ارسطو، الذي لا يعرف الخليقة ولا يتفاعل معها، وإله التنوير الربوبي: خالق غائب ترك الكون يعمل ذاتيًا. وهذه الآلهة بكلّ تأكيد لا تمت بصلة بإله الكتاب المقدس، الذي يحمل كل الأشياء بكلمة قدرته، ويتداخل في التاريخ والخليقة والخلاص.
لهذا يحذّر الرسول بولس من الفلسفة بوصفها نظامًا يسبي العقل:
«انظروا ألا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل… وليس حسب المسيح» (كولوسي 2:8).
قد يُقال إن بولس نفسه اقتبس من شعراء اليونان. وهذا صحيح، لكنه لم يتبنَّ الفلسفة كنظام، بل استخدم قبسات من الحق أبقتها نعمة الله العامة وسط ظلمة الفكر البشري.
وهل ننسى او نتجاهل كيف ساق بولس مواجهة صريحة بين حكمة العالم وحكمة الله؟ وقال إن "حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله" (1 كو3: 19). وسماها "حكمة الناس" (1كو2: 5) وحكمة "حسب الجسد" (1كو1: 26). "وحكمة من هذا الدهر" (1كو2: 6). فالعقل الطبيعي رأى الصليب جهالة، بينما هو في الحقيقة ذروة الإعلان الإلهي.
الحكمة التي لا تنطلق من الصليب، مهما بدت عميقة، ليست فقط عاجزة عن خلاص الإنسان، بل تُدينه، لأنها تستبدل حق الله بالكذب.
الخلاصة
الفلسفة كديانة للعقل هي نقيض للإنجيل، والحكمة الحقيقية ليست ثمرة اجتهاد بشري، بل ثمرة إعلان إلهي، وأي محاولة لدمج الإنجيل بفلسفات بشرية، مهما بدت نبيلة، تنتهي بتشويه الإنجيل.
الإنجيل وحده هو حكمة الله للخلاص، وكل حكمة لا تمر من الصليب، تبقى — في جوهرها — حماقة مزيّنة.