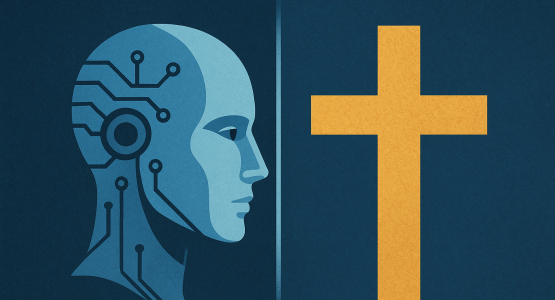مقدمة
لست أظن أن في الوجود قصة أبدع وأجل وأجمل من قصة تجديد القلب البشري، قصة المعركة الخفية بين المسيح والشيطان، بين النور والظلمة، بين الحق والباطل، بين السماء والجحيم. هي القصة التي تقف الملائكة والشياطين جميعًا شهودها المترقبين القلقين المتحفزين، هي القصة التي تهتف لها ملائكة الله ويندب لها الشيطان وأتباعه وزبانيه الجحيم، من لنا بالقلم الخفي العظيم يقص علينا قصة كل قلب غزته نعمة المسيح؟ من لنا بمن يقص علينا أطرف قصة وأروعها!؟ قصة الأزلي يتعقب النفوس البشرية، قصة السيد يقف على الباب في حنان ولطف وعطف وصبر وجود، دون كلل أو ملل أو إعياء. سائلاً الدخول والضيافة والبقاء. كلنا نهيم على وجوهنا في هذا الكون لا نعرف راحة أو غرضًا أو معنى أو هدفًا منشودًا، كلنا على الجبال بين الشوك والضيعة والهلاك خراف ضالة يسعى وراءها الراعي العظيم، كلما جوابون أفاقون ضالون تمتد وراءنا في الأفق البعيد عينا الأب القلق الحزين تنتظر رجوعنا من أرض الجوع ومرعى الخنازير.. ها الابن في طريقه إلى العودة! وها الأب لا يكاد يصبر حتى يجيء، إنه بشوق عميق يسعى إليه ويركض للقائه إنه يحتضنه ويقبله ويلبسه الثوب والخاتم والحذاء، يذبح العجل المسمن والبيت كله يموج بالفرح والرقص والغناء.
قصة ليدية بياعة الأرجوان قصة جميلة نموذجية لسعي الله الحثيث وراء القلب البشري، السعي الذي لا يتعب أو يكل أو ينتهي، السعي الذي يسخر الشوق والتعب، المادة والعاطفة، الإنسان والطبيعة، الليل والنهار، النوم واليقظة، الخفي والمنظور، حتى يغزوه ويمتلكه،... منع الروح بولس من أن يوغل في آسيا ويتكلم فيها بكلمة الله، وبعث إليه وهو قلق مرتبك حائر لا يدري كيف يتوجه برجل مكدوني يستغيث: ان «اعبر إلى مكدونية وأعنا» وعبر بولس إلى هناك، عبر ليغزو القلب الأول في أوربا للمسيح، ومن جمال التوفيق أن يكون هذا القلب قلب امرأة لا رجل.
هذه هي المرأة التي أرجو أن نتأملها الآن من نواح ثلاث: المرأة التي فتح الرب قلبها، كيف فتح الرب هذا القلب، الثمار الحلوة لهذا القلب المفتوح.
المرأة التي فتح الرب قلبها
لست أدري لم هفا بالنفس وأنا أذكر ليدية أن أتذكر أنها أسيوية المولد شرقية؟ أهو نازع من نوازع الأثرة يهتف بنا نحن الشرقيين أن نفخر أن القلب الأول للمسيح في أوروبا كان قلبًا شرقيًا خالصًا محضًا؟ أم هي الحقيقة العظمى تتابعنا بفيض من الفرح والجزل عميق أن الشرق دائمًا أستاذ الغرب وملقنه الدين؟ على إنه ينبغي أن نذكر أيضًا في روح من الحق والامتنان أن الغرب قد رد الوفاء جميلاً في جيوش مرسليه العظام البواسل حين أصيب الشرق بمحنته الكبرى التي تركته في أشد ظلام وأتعس فوضى... ولا أنسى أيضاً أن ليدية لم تكن رجلاً بل امرأة، وأن ازدهار المدنية الأوروبية، يرجع قبل كل شيء وأول كل شيء، إلى أن المرأة فيها سبقت الرجل إلى معرفة المسيح، وستظل الكنيسة في أوروبا وسائر أرجاء المعمورة شامخة قوية موطدة الأركان طالما كانت المرأة فيها قبل الرجل ومن ورائه المسيح.. إنها عندئذ ستقدم لنا أنجب الأطفال وأكمل الرجال، بل إنها يومئذ ستنفث في كل شيء روحًا سحرية ماجدة عظيمة،... ولدت ليدية في مدينة ثياتيرا في مقاطعة تحمل اسمها، وكانت لثياتيرا شهرة بالغة في الصباغة وصناعة الحرير، ونحن نعلم من قصة الكتاب أن ليدية كانت تتجر في الارجوان لكننا لا نعلم شيئًا عن السبب الذي دعاها إلى هجرة بلدها والانتقال إلى فيلبي، ألأنها لم تصب حظًا أوفر من النجاح رجته في مكان آخر؟ أم لأنها كما يظن البعض قد قضى زوجها في ثياتيرا، فآثرت المرأة أن تبتعد ما أمكن ببيتها وتجارتها في المكان الذي فجعت فيه بوفاة زوجها، تتلمس شيئًا من الراحة والنسيان والعزاء،لا نعلم! الله وحده يعلم. كما ولا نعلم فيما أظن ماذا يقصد الكتاب بعبارة «أهلها» أهم أولادها وهل كان لها أولاد؟ أم هم خدمها؟ أم العمال المساعدون الذين كانوا معها في تجارتها؟
على مسرح الحياة تقف أمامنا هذه المرأة جريئة قوية باسلة لا تروعها غربة أو يهزمها بعد، أو يقهرها كفاح الحياة، فهي تنأى عن أهلها ومدينتها وعشيرتها لتطلب الحياة والتجارة في بلد بعيد، كما أنها كانت قوية التفكير بارعة الاقناع سديدة الحجة ولعلها قد اكتسبت الشطر الأكبر في هذه الخلة مما ألفته من التعامل التجاري مع الناس، فقد استطاعت بأسلوب جميل رقيق لبق أن تقنع بولس الأبي أن يدخل بيتها، ويخيل إلينا أيضاً أنها كانت قوية الشخصية من أولئك اللواتي يستطعن أن يفرضن شخصيتهن على الآخرين لا بالاستبداد والتحكم والعنف بل بسحر الإعجاب والجاذبية والتقدير، وهذا يبرز جلياً في تأثيرها على بيتها ومن معها، لأن الكتاب يبين أنها ما أن اعتمدت حتى اعتمد أهل بيتها معها، وهل ننسى أنها كانت امرأة كريمة فاض كرمها وتابع بولس أينما ذهب نسيم رائحة طيبة في المسيح يسوع.
كيف فتح الرب هذا القلب؟
نستطيع أن نفهم كيف فتح الرب قلبها اذا تأملنا في أمرين: الممهدات لهذا الفتح، طريق هذا الفتح.
الممهدات لهذا الفتح
وهذا يقتضينا رجعة قليلة إلى الوراء، هل كان حقًا وفاة زوجها أول نداء وجهه الله لهذا القلب، كما يريدنا أحد المفسرين ممن تناولوا شخصيتها أن نفهم؟ وهل كان الحزن ذلك الصوت القوي العميق الذي يرسله الله إلى نفوس الناس لينفض عنهم غبار المادة، وما يرين على قلوبهم من زهو وكبر واعتداد، هو أول رسول سماوي؟ أم أن نفسها كانت من تلك النفوس التي تستجيب لنداءات أعلى مما يبكي الناس ويدعوهم نداء السمو عن الاسفاف الذي هوى إليه الأمم، نداء الشبع والري الذي لا تجده في معبودات ثياتيرا وآلهتها وأصنامها.. الذي نعلمه أنها صدفت عن هذه الوثنية، ونزعت عن خرافاتها، وبحثت عن جناحين تحلق بهما إلى الإله العلي إله السماء: «قد جعلتنا لنفسك وقلوبنا لن تجد الراحة إلا بين يديك» هكذا صاح أوغسطينوس المتعطش إلى الله. ولقد وجدت - وعلى الأرجح جدًا في مدينة ثياتيرا - ما يرضي رغائبها وأشواقها في الديانة اليهودية فتهودت، وسارت في الحياة شديدة الورع متعبدة لإله إسرائيل، ولما ذهبت إلى مدينة فيلبي، وبحثت عن مجمع أو يهود يصلون فلم تجد - وقد كان التقليد اليهودي يجيز لعشرة من الرجال على الأقل أن ينشئوا مجمعًا، إذا جمعهم مكان ما، ويظهر أن فيلبي لم يكن بها هذا العدد - اجتهدت أن تجتمع كل سبت مع أترابها في مكان هاديء منعزل خارج المدينة على ضفة نهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة، وحيث يسهل عليهن العبادة والاغتسال والتطهير، إلى هذا المكان جاء بولس، جاء ليغزو القلب الأول للمسيح في أوروبا، جاء ليضع قدم الفادي للمرة الأولى على الأرض الأوروبية العظيمة ومن استطاع أن يدرك عظمة هذه الساعة الخالدة في تاريخ أوروبا والغرب، من استطاع أن يستوعب ما فيها من بذرة الحق والنور والحرية والمدنية والخلود. هذا الرجل الصغير القزم المريض كما كان يحلو لرينان أن يدعوه أشعل في تلك اللحظة أوهج شعلة في تاريخ الحضارة والرقي الإنساني. على ضفاف هذا النهر حدثت معركة من أهم المعارك الحاسمة في التاريخ الروماني. المعركة التي وطدت أسس الإمبراطورية الرومانية العظيمة حين هزم اكتافيوس وانطونيوس بروتس وكاسيوس، لكن هذه الإمبراطورية رغم امتدادها وعظمتها، كان يطل عليها في الأفق البعيد وجه الريك القوطي الذي داس مجدها وهوى بعظمتها إلى التراب والحضيض.. أجل انتهت روما وتلاشى ذكرها بين الناس، وعفا الزمان على كاسيوس وبروتس واكتافيوس وانطونيوس وأباطرة الرومان أجمعين، وتبقى فقط على وجه التاريخ ذلك الرجل العظيم الهائل بولس، ورسالته التي غيرت معالم أوروبا، وشادت إمبراطورية أروع وأجل تتحدى البلى والفناء والانهيار.
طريقة هذا الفتح
ان لله طرقًا عجيبة في فتح القلب، ولعله لم يعامل أبدًا قلبين معاملة واحدة، فهناك قلوب صلدة صلبة، وأخرى هادئة وادعة ساكنة، هناك قلوب تهرع إلى الله مدفوعة بنداء الجمال، وأخرى تأتيه فزعة مروعة من مخاوف الموت، وهناك قلوب تأتي إليه لأنها تحن إلى السماء وموسيقى السماء ومجد السماء، بينما تقرب منه أخرى خوفًا من الجحيم وعذاب الجحيم ورهبة الجحيم.. تقترب منه بعض القلوب إذ ترى نورًا أبهر من الشمس يرهبها كبولس، وأخرى إذ تفزع من زلزال يروعها ويقض مضجعها كسجان فيلبي، وثالثة إذ يأتيها صوت عميق يناديها بتفاهة الدنيا وأوهامها وأباطيلها وغرورها... رأى الأخ لورنس شجرة يعمل فيها الذبول، تساقطت أوراقها وبدت جرداء، ففزع إذ رأى في هذه الشجرة صورة حياته تتجرد من كل جمال، فقدم نفسه لله ليضحى شجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح، أجل هناك ملايين الوسائل المختلفة التي يستعملها المولى في جذبنا إليه، فأي طريقة بلغ بها قلب ليدية؟ استعمل لوقا في الكلمة «فتح» لفظا فريدا انفرد به وحده في العهد الجديد، والكلمة تعني في الأصل «حل» أو «سرح» أو «فصل» ولعلك قد رأيت الصوف أو الشعر المتشابك يشط ويسرح ويرتب، هذا هو المعنى الدقيق للكلمة. كانت الحقائق أمام ليديه مختلطة يأخذ بعضها برقاب بعض، فجاءها بولس ليفصل بين الحق والباطل، بين النور والظلمة، بين القبح والجمال جاءها بولس ليرسم لها الطريق الفاصل بين الله والشيطان، وما أن وضح أمامها هذا الطريق حتى سارت وراء الله، وآمنت واعتمدت.
لعل صديقنا القديم الذي هتف: «امتحني يا الله واعرف قلبي. اختبرني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقًا أبديا». كان رجلاً يحس صعوبة الفصل بين مسالك الموت وطرق الحياة، بين مواقع النور وأوضاع الظلال. نورًا أكثر!! تلك صرخة جوتة في ضجعة الموت. وهي أبدًا صرخة النفس البشرية الفزعة المروعة في دنيا الأشباح والظلام، الدنيا التي تلبس القبح ثوب الجمال، وتعلو بالرذيلة على هامة الفضيلة، وتضع للشر والأثم والفساد والطمع والحقد وما أشبه من الرذائل أسماء ذاهية ماجنة خليعة، وفي الوقت عينه تلقي بالمحبة والبر والطهارة والخير والوداعة واللطف واليثار والإحسان وكل فضيلة تحت أقدام الأشرار المستهزئين العابثين الدائسين.. ما رسالة المسيحية لدنيا كهذه؟ هي رسالة بولس التي أجملها السيد له وهو على أبواب دمشق: «لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع القديسين» ولقد كشفت هذه الرسالة الأوضاع الحقيقية للآلاف والملايين من الناس، فجعلتهم ينحون مع تشارلس كنجسلي لحكمة وعظمة الثالوث الأقدس، ويتمشون في سفوح الجبال مع وردثورت كمن يتمشى مع الله في معبد، ويصيحون مع صموئيل رزر فورد: إن العالم كله لا يقوم في ضوء النفس الخالدة بأكثر من مليمين. ويغنون مع يوناثان ادواردز لكل جميل في الطبيعة لأنه خلق بابن الله ولمجده، ويصرخون في حزن وألم مع نيوتن وهويتفيلد واسبرجن ومودي والجنرال بوث والوعاظ قديمًا وحديثًا لأجل خلاص الآخرين وفداء النفس البشرية.
الثمار الحلوة لهذا القلب المفتوح
وما أجمل حقًا هذه الثمار وأسرعها وأنضجها وأكملها، إنها لم تظهر فقط في أهل بيتها الذين ترسموا خطى إيمانها فتبعوها، بل في كونها أيضًا قد جعلت من بيتها مكان الاجتماع والعبادة وحين خرج بولس وسيلا من السجن ذهبا إلى هناك ووجدًا الأخوة مجتمعين، كما أنها لفرط تعلقها بالله تعلقت بخدامه، جاهدت مع بولس ورفاقه حتى أقنعتهم بقبول ضيافتها، وأظنه من المفيد والطريف معاً أن نتذكر أن الكلمة «فألزمتنا» المعبرة عن ضيافة ليدية، وردت مرة أخرى فقط في العهد الجديد حين جاهد تلميذا عمواس في اقناع السيد بأن يمكث معهما «فألزماه قائلين امكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار» وهل قصد الوحي بهذا أن يرينا صورة حلوة للضيافة بالنسبة للضيف والمضيف معًا، أن بولس كان سيده أبيًا عزيز النفس رقيق الشعور دقيق الإحساس، وهو يرهق نفسه ويثقل عليها حتى لا تبدو - أو على الأقل يظن - أنها ثقيلة على الآخرين، وفي الوقت ذاته نرى ليدية كتلميذي عمواس تعبر عن روح الضيافة الحقة التي يجب أن تسود أتباع المسيح وتلاميذه جميعًا. كانت ضيافتها ضيافة النفس الكريمة الملحة المشوقة التواقة إلى استجابة طلبها كما أنها لم تحسب هذه الضيافة تفضلا منها بل امتياز لها: «إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا». لقد اعتقدت أن قبول بولس دخول بيتها مغنم كبير لها وبركة لا تعوض.. أجل أنها لم تكن تنظر إلى الرسول بل إلى ما ورائه. إلى الرب الذي تكرمه في شخص رسوله.. ما أحوجنا كشرقيين ومسيحيين معًا أن نستعيد هذه الروح التي أخذت للأسف تذبل وتتلاشى بفعل المدنية الغربية وتأثيرها فينا.
لا أود أن أختم الحديث عن ليدية دون أن أذكر أنها ومدينتها أشتهرتا بروح السخاء في العطاء والتوزيع. كان القلب الفيلبي أفضل القلوب وأكرمها من هذه الناحية. لقد عبر عن شكره لله بما يعد في الواقع المقياس الحقيقي للحياة المتعبدة. بتقدمة المال.. وها نحن نرى بولس يذكرهم بكل ثناء في ختام رسالته إليهم: «ثم أني فرحت بالرب جدًا لأنكم الآن قد أزهر أيضاً مرة اعتناؤكم بي الذي كنتم تعتنونه وأنتم تعلمون أيها الفليبيون أنه في بداءة الإنجيل لما خرجت من مكدونية لم تشاركني كنيسة واحدة على حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم. فإنكم في تسالونيكي أيضًا أرسلتم إلى مرة ومرتين لحاجتي، ليس أني أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت. قد امتلأت إذ قبلت من ابفرودتس الأشياء التي من عندكم نسيم رائحة طيبة وذبيحة مقبولة مرضية عند الله. فيملأ إلهي كل احتياجاتكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع ولله وأبينا المجد إلى دهر الداهرين. آمين»...