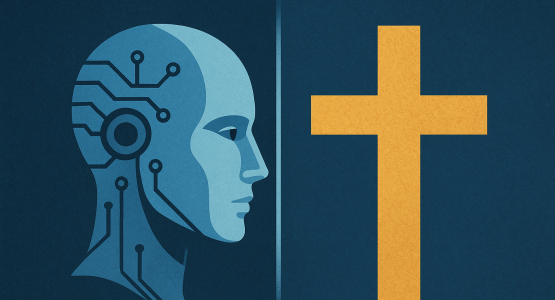مِيَاهٌ كَثِيرَةٌ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْفِئَ الْمَحَبَّةَ، وَالسُّيُولُ لاَ تَغْمُرُهَا .. إِنْ أَعْطَى الإِنْسَانُ كُلَّ ثَرْوَةِ بَيْتِهِ بَدَلَ الْمَحَبَّةِ، تُحْتَقَرُ احْتِقَارًا (نشيد الأنشاد 7:8) – الحب هو عاطفة جياشة تواقة للكمال. ولا كمال في الخليقة إلا لله لذلك كل من يحب هو يتوق الى الله نفسه .. ومن يعرف الحب يكون قد مس الله في مستواه الحاد بالروح ولو للحظة – عملت تلك اللحظة كل هذا التوق المستمر إليه – وغيرت حياته كليا إلى حياة روحية منتصرة بالغة الملء الإلهي الكلي حتما في نهايتها. إن من يحب يكون جزء من الله وقد عاد وتوحد معه.

القوة الفاعلة في الحياة:
الحياة في تعريفها هي حالة شعورية عاطفية بالوسط المحيط بالكائن والتفاعل معه والإستجابة لمؤثراته مما يدعم الشعور بالوجود المريح أو الناجح اللذيذ أو بالفرحة به. إن الجمادات لا تعيش بل تتواجد. في حين أن كل الكائنات الحية تعيش لأنها تملك شعورا بدرجات متفاوتة من الرقى. ومتى سمى هذا الشعور الى درجة عالية فانه يدرك بالبر الكامل ويتوحد به ويدرك الصفاء الروحي الممتع للغاية مما يحقق الحياة لدى هذا الكائن. إن الحب والمشاعر التي تقيم الإنسان من الضعف الى القوة في منتهاها هذا تسمح له بمعرفة الرب وبالإيمان المسيحي وباستلام الخلاص. ولا يوجد في الكائنات الحية من أدرك الملء الإلهي إلا الإنسان متى آمن. لذلك فإن القوة – التي للحياة لا للتواجد المادي الصرف – تكمن في التعامل مع الشعور والإحساس لا مع الماديات. إن الماديات تعمل إستمرارية للكائن من دون حياة في تعريفها الروحي لا البيولوجي الصرف. لذلك فإن الإيمان بالله من أقوى ما تنتجه الحياة الروحية لأنه لا يتم إلا بعمل الروح. لا مؤمن يؤمن بعقله البشري المحدود بل بشعوره وبوجدانه. ومتى آمن يحل الملء الإلهي به متمثلا في الروح القدس الذي لله فيكون هو المحرك له والداعم والمنتج لكل بر منه. وهو يرشده الى أسرار وعلوم روحية مخفية عميقة عن الوجود والخلق لا يدركها إلا من يعمل بالروح لا بالجسد أو بالفكر البشري القاصر. كل تلك العناصر الروحية هي التي تنتج ما يعرف بالحياة وهي قوتها الفاعلة. الحياة مع الرب الإله وفي معيته والوحدة معه والتمجد بحمل إسمه القدوس تكون في منتهى القوة والإستمرارية. لذلك لا حياة – حالية أو آتية – لغير المؤمن.
التضحبة والحب:
الحياة – في طبيعتها الروحية تلك – تستمد قوتها من التضحية والبذل من دون مقابل لا من التعامل المادي البحت وتبادل السلع والخدمات. فالوجود له قيمة غير محدودة ولو سعر – أخذ سعرا – رخص بشدة وفقد قوته الفاعلة الكامنة في عمل الروح به. لكن في التضحية والبذل من دون مقابل مادي فوري قوة فاعلة كبيرة لأن التضحية لا تكون إلا ممزوجة بعنصر الحب. فالإنسان لا يضحي إلا من أجل من أو ما يحب. وكل من ضحى بوقته أو بماله أو بنفسه أو حتى بجسده فإنه ينتج أثرا قويا ومستمرا لتضحيته في الحياة لأن الحب من خامة المطلق الذي هو مصدره وهو الله. وقد تجلت التضحية بكامل بهائها وصورها في تضحية الله بإبنه وحيده القدوس يسوع المسيح من أجل فداء العالم الذي سقط ورده إليه. ذلك عندما أرسلة ممجدا الى العالم في جسد بشري ليموت عوضا عمن يؤمن به – من اليهود أو من الأمم – ليصيروا أبناء الله المخلصين المعدين لوراثة الملكوت الإلهي الكامل الأبدي الآتي. فعل الله ذلك لأنه أحب العالم حتى المنتهى. لأَنَّهُ هكَذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ، لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ. 17لأَنَّهُ لَمْ يُرْسِلِ اللهُ ابْنَهُ إِلَى الْعَالَمِ لِيَدِينَ الْعَالَمَ، بَلْ لِيَخْلُصَ بِهِ الْعَالَمُ (يوحنا 3: 16- 17).
هذا الحب الإلهي:
إن أهم ما تنتجه الحياة الحقيقية هي شعور المحبة الذي يكون عليه المؤمن. المحبة للعالم – كخلق لله يهوه القدوس – من دون أن يعبده أو أن يتخذه وثنا معتقدا أنه سبب لتلك الحياة البارة المخلصة من الخطية الموروثة عن آدم وأثرها المعيق للتقدم الروحي. إن الحب لا يشعر به كثيرين من البشر ذلك الذين لم ينالوا الخلاص. من يحب يكون من الله لا من عمل الطبيعة المادية وحدها – فآدم من دون روح من الله يكون كائن حي كباقي الكائنات بلا قداسة ولا ميزة – إن الله هو المحبة نفسها. َمَنْ لاَ يُحِبُّ لَمْ يَعْرِفِ اللهَ، لأَنَّ اللهَ مَحَبَّةٌ (1 يوحنا 8:4). ومتى أحب الإنسان الوجود من حوله الحب المقدس الصحيح فإنه يدلل على عمل النعمة الإلهية فيه. ويكون واحدا من أبناء الله المستعلنين ببهاء الرب في الوجود. إن الله يمن على أبناؤه على الفور بقوة المحبة التي هي القوة الفاعلة الحقيقية للحياة والداعمة لها في شكلها المادي والروحي معا. الله المحب للعالم – خليقته – قد سارع في إتمام خلاصه بعد سقوطه نتيجة لسقوط آدم ونسله فيه. فأرسل خلاصه متمثلا في المسيح – إبنه وحيده القدوس – ليموت عمن يؤمن به ويؤمن بهذا الموت النيابي عنه من أجل تبرره وإعادته لكماله وللمحبة للسلامة والمتعة الحقيقية التي في العالم والتي خصها الله فقط للمؤمنين. هذا الشعور الخارق القوي بالحب المتدفق الى مالا حدود من الله للعالم ولخليقته التي على صورته ينتقل من ملئه الى المؤمنين وفورا. ويكونون على نفس صورة الله من حيث إنتاج الحب دعمه فتستعيد الأرض سريعا فردوسها المفقود الذي يعمه المحبة والثقة مما ينتج أمنا. إن الحياة من دون أمن تكون في منتهى البشاعة. والحياة الفردوسية الحقيقية هي الى يتحقق فبها الأمن والأمان للفرد. هذا ما يجعل الفردوس المفقود يترائى للمؤمن وهو في معية الله في لحظات خارقة من التمجد الإلهي والوحده الروحية المهيبة به والشعور القوي بمدى غزارة الحب الإلهي الذي دفعه الله للمؤمنين كثيفا من دون حساب. تلك اللحظات التي يمر بها المؤمن كل حين في مشوار حياته الأرضية.
العالم في حاجة الى الحب:
مرت البشرية عبر العصور التي تلت سقوط آدم بمراحل مريرة من الوحشة الناتجة عن الإنفصال عن الله والإعتماد على الإرادة والفكر البشري من أجل إسترجاع الملكوت المفقود. لقد حاولت البشرية طويلا إنتاج الثقة والأمان والسلام الكامل من دون جدوى. عملت أنظمة وحكومات بشرية كثيرة وقوانين متنوعة من أجل إنتاج الأمان الذي يدعم الثقة في الحياة ويعيد إليها ذلك الفردوس المفقود بلا جدوى. وفي الأزمنة الأخيرة – تلك التي نعايشها جميعا في الوقت الحاضر – أثبتت الدراسات إنه كلما وضع تشرعا لمنع الجريمة فإنها تزداد لا تتناقص وكلما زادت القهر السياسي كلما نمت الحريات فكلما إزداد التشدد إزداد التمرد. وفي التشريع نفسه يظهر ما يعرف "بثغرات القانون" التي تبطل قوته الفاعلة. مما ينتج مزيدا من الجرائم وانعدام الأمن في المجتمعات البشرية التي تحاول أن تقيم نفسها بإرادتها البشرية من دون الإعتماد على الرب الذي خلقها ووعدها بالحماية لو توحدت معه. إن الأمان الحقيقي يتحقق بعمل النعمة الإلهية بين الناس وفيهم مما يحولهم من الثقة بأنفسهم إلى الثقة في الله القدير والإلتزام بعمل وصاياه فالقوانين الإلهية ليس بها ئغرات. وهذا يكون بعمل الروح القدس العجيب الحال فيهم بعد الإيمان. وروح الله لا ينتج إثما أبدا بل يعمل طمأنينة وثقة وأمانا ومحبة وسلام بين الناس في المجتمع أثناء تعاملاتهم مما يقويه بالفعل ويمنع حدوث الإعتداء أو الجريمة فيه ويتمم أي مشروعات مطلوبة. وبالتدريج مع ازدياد النعمة والمحبة والثقة بين الناس – الذين عرفوا الله – ينتشر هذا الحب الطارد للروح الشرير منه منتج كل أثم ومرارة وتوتر في الحياة البشرية وينزوي مروجيه وتتعطل فاعليتهم إلى أن يتلاشوا للأبد. فيتحقق الفردوس الأرضي شيئا فشيئا وينمو ويزدهر فقط بعمل تلك النعمة اللا منظورة في المؤمنين الأبرار.
كلمة السر التي تفك بؤس العالم الحالي:
إن كلمة السر لرد العالم لفردوسه المفقود هي: الحب. حب الناس لبعضهم البعض وحب البيئة المحيطة مسكننا. وهذا الشعور الرباني يعمل مراعاة لكل إنسان ودعما له يقويه بيولوجيا وروحيا الى اللا حدود مما يجعل الحياة الأبدية في المتناول. لقد أوصانا المسيح بأن نحب بعضنا البعض. وَصِيَّةً جَدِيدَةً أَنَا أُعْطِيكُمْ: أَنْ تُحِبُّوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا. كَمَا أَحْبَبْتُكُمْ أَنَا تُحِبُّونَ أَنْتُمْ أَيْضًا بَعْضُكُمْ بَعْضًا. (يوحنا 34:13). هذا هو الطريق لكي يسترد العالم عافيته وإصلاح حاله ويتحقق البر الإلهي الكامل فيه ويكون داعما للحياة الروحية والجسدية الأبدية الآتية للمؤمنين به. إن البشرية تمر حاليا بمرحلة عسيرة فيها يعيد المسيح ترتيب العالم على أساس رباني سليم يسبق حضوره بالجسد إليه. فلابد أولا أن يزال العالم الوثني ويتوقف تحكم المال في الحياة البشرية وتزال كل سلطة وإرادة بشرية تحكم في العالم قبل مجيء ملكوت الله وحكمه هو إليه. هذا ما سبب الإضطراب – الغير مسبوق – الذي تمر به البشرية في الوقت الحاضر. ذلك الذي أضعف الحب بشدة فيه وقدس الأفراد والماديات والأشخاص أصحاب السلطة به. فعبد الناس الذهب كاليهود الذين عبدوا العجل من قبل في سيناء عندما تأخر موسى عليهم وهو يتلقى الشرائع على الجبل. لكن مسيحنا جاء – وسار على الأرض وباركها للأبد – وها هو في حالة حضور بالروح حاليا وسطنا يزبل كل سلطان – من دونه – متسلط علينا نحن خاصته الذين إختارنا لنكون أبناؤه المفديين بدمه. هذا العالم الحالي المتوتر جعل المؤمنين – الذين قد عرفوا الحب – يتألمون بشدة بسبب شحه فيه. لكن فالنتشجع ف: فِي الْعَالَمِ سَيَكُونُ لَكُمْ ضِيقٌ، وَلكِنْ ثِقُوا: أَنَا قَدْ غَلَبْتُ الْعَالَمَ (يوحنا 33:16) هكذا نبأنا المسيح. إن النصرة النهائية الكاملة قريبة جدا فكثيرون قد انضموا الى الكنيسة. ف: لاَ يَقُومُ الضِّيقُ مَرَّتَيْنِ (ناحوم 9:1).
الحب والمادبات:
يقول قائل: إن الحب لا ينتج طعاما ولا شرابا في عالم نحو خمسه يتضور جوعا!. أو أن الجائع لا يحب. أهو مقبول أن يكون الجائع كاره لخلق الله من حوله؟. بالطبع لا. فالجائع يكون قد ترك الله فتركه لأن الله لا يترك أبناؤه أبدا ومن يتكل عليه بحق لا يجوع. هذا وعد من الله للبشرية الآتية كلها منذ أن أودع آدم جنة عدن. وَغَرَسَ الرَّبُّ الإِلهُ جَنَّةً فِي عَدْنٍ شَرْقًا، وَوَضَعَ هُنَاكَ آدَمَ الَّذِي جَبَلَهُ. (تكوين 8:2). الله لا يضع مخلوقا كاملا من صنعه في نقص أو إحتياج. إن الأقتصاد وشراسة الفكر الرأسمالي هما من إنتاج البشر لا من عند الله. وها هي تلك الأنطمة البشرية تثبت بالتجربة إنها تنتج جوعا وفقرا لا شبعا ولا غنى. تنتج قهرا لا حرية في منتهاها. فلا غنى حقق شبعا حقيقيا عالميا بل كلما إزداد المال في العالم كلما ازدادت شقاوته لا سعادته. وخضع ملايين الى عبودية العمل الوظيفي من أجله وفقدوا نعمة التلذذ بالحياة. وأفراد هذا العالم البائس هنا يشعرون بالتعلق بالمال أو بحبه ويكونون مستعدين للقتال من أجل حمايته من السلب متى اكتسبوه. ويسلكون في الإثم وعمل الحيل الشريرة من أجل المزيد منه بشكل مرضي أليم يثير الشفقة. وهم لن ينتصروا بكل أموالهم – مهما بلغت – على الموت القادم عليهم وبشكل محتوم. لأَنَّ مَحَبَّةَ الْمَالِ أَصْلٌ لِكُلِّ الشُّرُورِ، الَّذِي إِذِ ابْتَغَاهُ قَوْمٌ ضَلُّوا عَنِ الإِيمَانِ، وَطَعَنُوا أَنْفُسَهُمْ بِأَوْجَاعٍ كَثِيرَةٍ. (1 ثيموثاوس 10:6). إن الإنسان ليس في حاجة الى كل تلك الأموال من أجل أن يشبع أو يكتسي أو يتعلم أو يسكن في منزل. كل تلك الأشياء قد ضمنها الله للمؤمنين من دون شقاء بل بمجرد عمل يسير به ثقة في الله وفي وعوده.
ما عسانا أن نفعل؟
إن المطلوب هو السعي نحو الكمال المفقود والتعلق به وعمل النمو الروحي المتواصل الذي يصبو إليه كل طالب لهذا الكمال .. ودراسة الكتاب المقدس والتفقة فيه – وهذا أصبح متاحا بسهولة ومجانا – للساعيين بجدية لبلوغ الحقيقة – ذلك بواسطة التكنولوجيا ووسائل الإتصال الحديثة – إن الإيمان المسيحي ينتصر على الموت بكل بشاعته وسطوته على البشر منذ السقوط وهو يضمن الحياة الكريمة للمؤمن من دون احتياج فهذا يسير على من قدر على الموت وغلبه .. لاَ تَهْتَمُّوا قَائِلِينَ: مَاذَا نَأْكُلُ؟ أَوْ مَاذَا نَشْرَبُ؟ أَوْ مَاذَا نَلْبَسُ؟ 32فَإِنَّ هذِهِ كُلَّهَا تَطْلُبُهَا الأُمَمُ. لأَنَّ أَبَاكُمُ السَّمَاوِيَّ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَحْتَاجُونَ إِلَى هذِهِ كُلِّهَا. 33لكِنِ اطْلُبُوا أَوَّلاً مَلَكُوتَ اللهِ وَبِرَّهُ، وَهذِهِ كُلُّهَا تُزَادُ لَكُمْ (متى 31:6-34) .. إن العامل في حياته بالحب وبالروح – الآتي من هذا المستوى الرفيع من المعرفة – لا العامل بالجسد أو بالماديات الغليظة يكون هو الكاسب .. ذلك لأنه يتحول من معتمد على نفسه القاصرة أو على القوانين البشرية في إقامه نفسه سعيدا مكتفيا الى التحول على الله والإعتماد عليه والتوكل الكامل على النعمة اللامحدودة الموعدة الآتيه مجانا من لدنه ليتحقق هذا الشبع وعدم الإحتياج في الدنيا وهذا على الله يسير .. كلنا ثقة – نحن المؤمنين – بذلك .. إن الحب – الذي هو من عمل الروح القدس – يجعل قيم الأشياء من حولنا لا محدودة ذلك في كنف الحبيب يسوع وتحت رعايته .. ومن هنا يكون من الممكن الحياة بأي مستوى إقتصادي .. فالقليل مع من نحب هو كثير لأنه مبارك بروح الله المحبة الثرية التي تعمل فيه وتجعل فوائده كثيرة ومتنوعة ومستديمة وتلغي أي فاقد أو خسارة قد يتعرض لها .. لُقْمَةٌ يَابِسَةٌ وَمَعَهَا سَلاَمَةٌ، خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَلآنٍ ذَبَائِحَ مَعَ خِصَامٍ (أمثال 1:17) .. إن الحب يمد بقوة منتجة عجيبة تقيم الحياة والتي فيما بعد تتحدى الفناء نفسه وتجعل تلك الحياة أبدية متحدة مع المعشوق الأول المحب الأكبر لنا الله الآب ياه يهوه العلي القدير الذي يوحد – بهذا الحب المهيب الصادر منه – نفوس كل المؤمنين ولا يجعل فيما بعد عداوة على الأرض .. فبعد أن كنا نحن نحن يوما ما الآن كلنا أصبحنا بالإيمان المسيحي يسوع إبن الله بروح واحد مقدس يجمعنا أبناء كثيرين لله الآب ..
إن الحب هو الأداة والطريق:
الحب هو من الله والكرة من الشيطان. وكل من يبادر بالحب ومن يعمل بالحب تكون أعماله به صفة الدوام والثبات والبركة والعطاء المتواصل. لا مبادرة بالعنف تنتج خيرا ولا عمل تحت الإكراة يثمر طويلا. في حين أن كلمة حب أو نصيحة من القلب تبقى وتثمر الى الأبد وتتواجد بوضوح وفاعلية على طول الأزمنة والعصور وتدخل في ذاكرة البشرية الجمعية ولا تمحى منها. أوصى المسيح: تُحِبُّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ (مرقس 31:12). هذه وصية خالدة ومفتاح لتحقيق الفردوس الأرضي المفقود من جديد على الأرض والغلبة على الشيطان. هذا الحب – الآتي من أعلى من عند الله – يشجع المؤمن ويقوى من الروح الإيجابية فيه فينتج بهذا البر وبتلك السعادة ما يكون فاعلا أيضا والى الأبد على تلك الأرض. أي يحقق ولو جزء ضئيل من الفردوس المفقود عليها. والمؤمن المحب لخليقة الله يمتد حبه من الفيض الإلهي الكثيف الذي استلمه الى كل البشر – من دون إستثناء – لدرجة أنه يحب المخطئين إليه. وكذلك يمتد حبه لغبر المؤمنين لكونهم من صنع الله أيضا ولأنهم في حاجة أشد من المؤمنين للمساعدة بعد أن ضللهم الشيطان. ولا يتمكن مبشر من رد طاغية الى رشده ويحقق البر المنشود به الا اذا أحبه أولا. ولا نصيحة أو وعظ يجدي مع من يكرهنا – وهم كثر في العالم – في وقت نحن نحبه عملا بالوصية: إِنْ أَحْبَبْتُمُ الَّذِينَ يُحِبُّونَكُمْ، فَأَيُّ فَضْل لَكُمْ؟ (لوقا 32:6). إن الكراهية تعمل تنافر يباعد الفكر عن التطبيق ويمنع ولوجه الى نفس المتلقي بل يوقف حتى الإستماع والفهم بيننا. في ذلك التعليم الصحيح تكمن مفاتيح المد الإلهي المنشود الى العالم. الحب والمحبة تطرد الخوف الذي هو من إنتاج الشيطان والذي يحول الحياة الى جحيم. الحب يتناقض مع التعاسة والحزن ويتوافق مع السعادة والبهجة التي نتمكن بها من الإطلاع الخارق بالروح على الملكوت الألهي – الحال من حولنا – وبمعرفة عميقة للحق لا يطلع عليها كل إنسان بسبب إقتصار عمل النعمة على البعض وليس على الكل. هَا مَلَكُوتُ اللهِ دَاخِلَكُمْ (لوقا 21:17). إن المؤمنين تتجلى فيهم صورة الله من جديد وقداسته ومحبته اللامحدودة للعالم وللناس كلهم به. فيكونون منيرين متجددين مضيئين يجذبون الآخرين من العالم الوثني المزعج المقيت – بهذا الشعور المريح – إليهم. يكونون كما هم الأطفال الذين لم يتلوثوا بعد بخطية ظاهرة تطفىء بهاءهم. وتكون صورة الله الصافية المحبة هي الظاهرة فيهم. هؤلاء الذين يرق وينجذب إليهم قلب كل مؤمن يسعد بالجمال وبالحب ويدرك قيمتهما وأثرهما في مد ملكوت الله من السماء الروحية الى الأرض المنظورة.